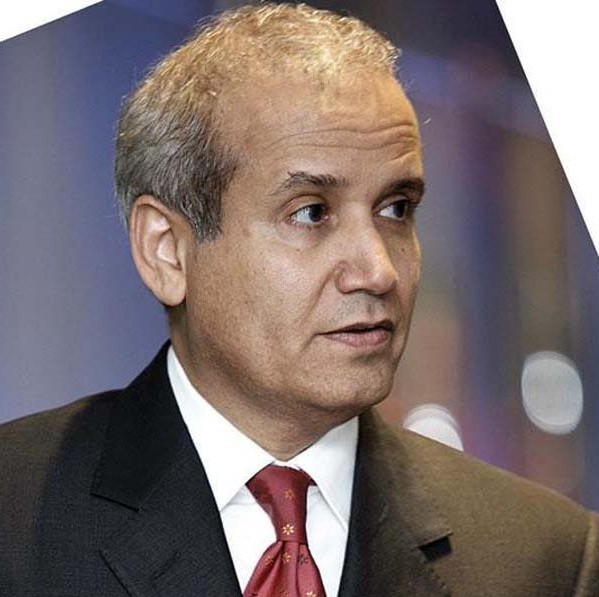تدوير المناصب الحكومية بات سمة ملازمة لتشكيل الحكومات، حيث تتكرر الوجوه ذاتها في كل حكومة جديدة، وتتبدل المسميات والحقائب، بينما يبقى الأشخاص أنفسهم، وكأن الوطن عجز عن إنجاب كفاءات جديدة قادرة على حمل المسؤولية. هذا المشهد لا يثير الاستغراب بقدر ما يثير القلق، لأنه يعكس أزمة عميقة في مفهوم الدولة وإدارة الشأن العام.
مع كل إعلان حكومي، تتجدد آمال الشارع بإصلاح حقيقي وتغيير ملموس، لكنها سرعان ما تتبدد حين يكتشف المواطن أن التشكيلة ليست سوى إعادة تدوير لأسماء سبق أن جُرّبت في مواقع مختلفة، أو في المواقع نفسها، دون أن تترك أثراً إيجابياً يُذكر. وهنا يبرز السؤال المشروع: ما الذي تغيّر إذا كانت الأدوات نفسها والعقول نفسها هي من تدير المشهد؟
إن حصر المناصب في دائرة ضيقة من الأشخاص يكشف خللاً واضحاً في آليات الاختيار، وغياب معايير الكفاءة والنزاهة، لصالح المحاصصة والولاءات والعلاقات الشخصية. هذا النهج لا يكرّس الفشل الإداري فحسب، بل يقضي أيضاً على أي فرصة لبروز قيادات جديدة تمتلك رؤية مختلفة وروحاً إصلاحية حقيقية.
الأخطر من ذلك أن تدوير المناصب يمنح الفاشلين فرصة الإفلات من المساءلة، فبدلاً من محاسبة المسؤول عن الإخفاق، يتم نقله من وزارة إلى أخرى، أو إعادة تعيينه في المنصب نفسه، وكأن الفشل مؤهل إضافي لتولي مناصب أعلى. وهكذا تتحول الحكومة من أداة لإدارة الدولة إلى نادٍ مغلق لتبادل المواقع والنفوذ.
البلد لا يعاني نقصاً في الكفاءات، بل يعاني من إقصائها. فهناك آلاف الخبرات الوطنية في الداخل والخارج، تمتلك علماً وتجربة ونزاهة، لكنها تبقى خارج دائرة القرار لأن المعايير لا تبحث عن الكفاءة بقدر ما تبحث عن الولاء والاصطفاف.
إن أي حديث عن إصلاح أو إنقاذ لا يمكن أن يكون ذا مصداقية ما لم يبدأ بكسر حلقة تدوير المناصب، وفتح المجال أمام دماء جديدة، واختيار المسؤولين وفق معايير واضحة تقوم على الكفاءة والقدرة والإنجاز، مع إخضاع الجميع للمساءلة دون استثناء. فالدول لا تُبنى بالوجوه المكررة، ولا تنهض بالعقول التي أثبتت فشلها، بل تُبنى بإرادة حقيقية للتغيير، تعترف بالأخطاء وتمنح الفرصة لمن يستحق، لا لمن اعتاد الجلوس على الكراسي.